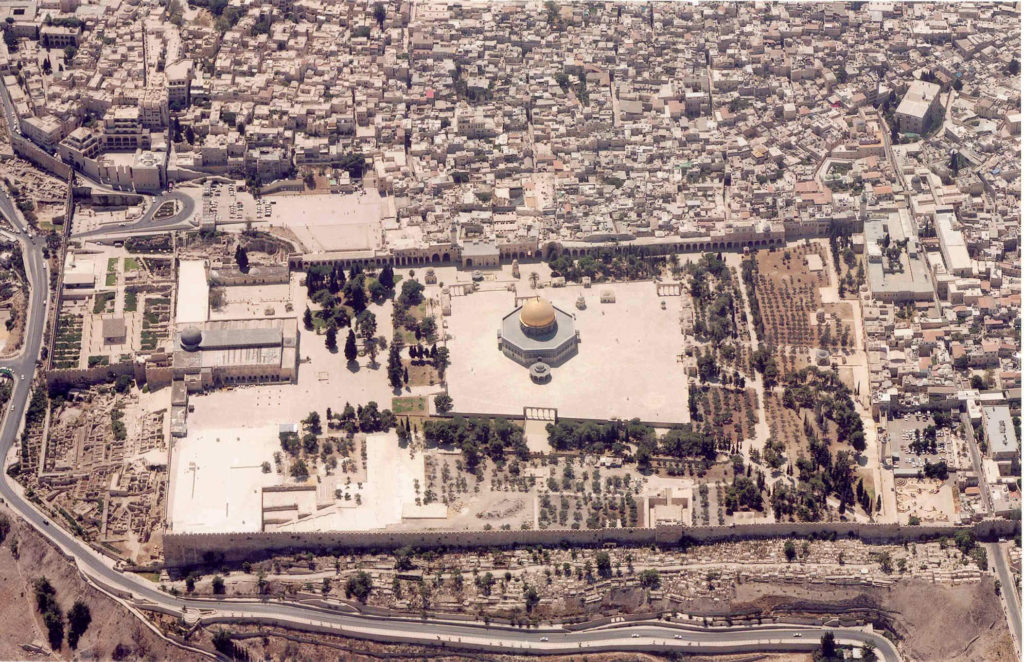تجديد الخطاب الديني -الإسلامي بالخصوص- في الزمن الأمريكي
-


My journey to Allah 💖 Korean Muslim Couple Love Story live in Morocco
-


رحلتي إلى الله 💖 قصة حب للزوجين الكوريين المسلمين يعيشان بالمغرب
-


عاملة إغاثة إيطالية تعتنق الإسلام رغم خطفها من جماعة إسلامية متشددة، فكيف علق الإيطاليون؟
-


Muslim Chinese Street Food Tour in Islamic China | BEST Halal Food and Islam Food in China
بقلم/ الكاتب الباحث السوري معتز الخطيب
اكتسب تعبير “التجديد” شرعيته من وروده في حديث نبوي شهير، ومع ذلك شهد عبر تاريخه التباسًا واشتباهًا أيضًا، نتيجة التنازع حول شرعية مدلوله، وهو وإن كان في التراث الإسلامي كاد أن يطابق مفهوم “الاجتهاد” بالمعنى الفقهي، فإنه بدءًا من بدايات القرن العشرين تحول من النص إلى الخطاب، واكتسب زخمه بعد خفوت وهج مدرسة الإصلاح التي نُسبت لمحمد عبده رحمه الله والتي قامت على أساس الوعي بالعصر، وبالفجوة الماثلة بين الغرب والعالم الإسلامي، وكانت فكرة مناهضة الاستعمار (الأوربي) والهيمنة الثقافية تقع في القلب من انشغالاتها. ومع ذلك بقي مشروع التجديد قاصرًا على فئات نخبوية ولم يتحول إلى عمل مؤسسي واسع، فضلاً عن حديث الصحافة.
لكن خطاب التجديد أو الإصلاح، منذ تاريخ 11 سبتمبر 2001م شهد تحولات مثيرة، فتحول من قرار داخلي، إلى مطلب خارجي للاستعمار الجديد (الأمريكي) ليسري بعد ذلك إلى قرار سياسي، وتلهج ألسنة النخبة الثقافية، والمؤسسة الدينية الرسمية بالحديث عنه، ويتحول إلى حديث الصحافة اليومية ويدخل فيه كل الاتجاهات الفكرية والدينية، ومن هم خارجها أيضًا.
إنه لا يمكننا الحديث عن مصطلح محدد للمشروع الأمريكي المتعلق بالخطاب الإسلامي الراهن، فتارة هو “تجديد” وأخرى هو “إصلاح”، وثالثة غير ذلك… إلخ، ويبدو أن “الإصلاح” هو الأكثر تداولاً في الخطاب الأمريكي، وهذا الإرباك سرى إلى الخطاب العربي الثقافي والديني الرسمي، فلا يمكن الحديث فيه عن “مصطلحات” محدودة بحد، فالسياسي مثلاً تارة يعبر بالإصلاح، وأخرى بالتطوير، وثالثة بالتجديد، والديني وجد في “التجديد” مفردة لها شرعيتها النصية فألح عليها، والأمر نفسه سرى إلى الثقافي.
ومع ممارسات “تنظيم القاعدة” وخطابه الديني-السياسي المشبع بالعنف ضد “الكفرة” من “اليهود والصليبيين”، وحديثه عن “حتمية الصراع بين الإيمان والكفر” تحول الإسلام إلى مشكلة عالمية، واتسع الصراع عليه -تفسيرًا وتوظيفًا– ليشمل كل التوجهات الإسلامية وغير الإسلامية، المتفقة والمختلفة مع القاعدة والأنظمة السياسية العربية والغرب، وخصوصًا أمريكا صاحبة مأساة سبتمبر، بمعنى أن “مصائر الإسلام التي كانت موضع نزال بين الإسلاميين والأنظمة العربية والإسلامية صار يشارك في تحديدها –أو يحاول ذلك- كل من يعتبرون أنفسهم متضررين من المتشددين المسلمين في العالم”.
بذلك أوجدت أحداث سبتمبر “مشروعية” -بمنظور أمريكا؛ “المتضرر” الأكبر من “الإرهاب الإسلامي”- للحديث عن التغيير والإصلاح، على مستويات مختلفة، وبأدوات مختلفة -بما فيها القوة العسكرية في أفغانستان والعراق- ومن ضمن مشروع التغيير هذا كان: “نشر الديمقراطية في البلدان العربية والإسلامية” و”تجديد الخطاب الديني” -الإسلامي تحديدًا- وتغيير مناهج التعليم، وملاحقة الجمعيات الخيرية، تحت عنوان “الحرب على الإرهاب” الذي صكته لهذا المشروع الطويل غير المحدود -زمانًا ومكانًا ومفهومًا.
هذا الملف يبحث “تجديد الخطاب الديني” بعد 11 سبتمبر 2001م (الزمن الأمريكي)، وقد تم تحديد أسئلته لتكون على أربعة محاور:
في المحور الأول: “الإسلام .. ومنعطف التجديد” تحدث المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد عن مثيرات التجديد، ومنطقه، ونشأة إشكالياته في سياقها الداخلي، ثم العالمي (الأوربي ثم الأمريكي)، وموقف القوى الاجتماعية المفارقة لمجتمعاتنا التقليدية من تطوير البنى الفوقية.
وفي المحور الثاني: “المشروع الأمريكي: تحديث الإسلام!” تحدث الباحث معتز الخطيب عن ملامح الرؤية الأمريكية لتجديد الخطاب الديني (الإسلامي) ضمن سياقها بناء على رؤية مركبة، ودراسة تحول مشروع التجديد من مطلب ذاتي إلى إرغام أيديولوجي خارجي (الاستعمار الجديد).
في المحور الثالث: “العنف.. والإصلاح الديني” بحث المفكر اللبناني رضوان السيد نشأة العنف الإسلامي في مفاصله الرئيسة، وعلاقته بالإصلاح الديني، محاولاً قراءة مصير المشروع الإصلاحي الإسلامي في عصر الإحيائية الإسلامية المتشددة.
أما المحور الرابع: وهو “التجديد الإسلامي وخطاب ما بعد الهوية” فحاول فيه الباحث السوري عبد الرحمن الحاج رسم تصور لمستقبل ما سمي بـ “الخطاب الإسلامي الجديد” (نشأ بعد سقوط الأيديولوجيا الماركسية) -التي حشرت الخطاب الإسلامي في هوس الهوية- وإدراك تأثيرات ومآلات أحداث سبتمبر والدعوة الأمريكية عليه.
طالع أوراق الملف:
أمريكا
أول رمضان لي كامرأة مسلمة
هذا العام خاص لأسباب عديدة. في حين أنها ليست السنة الأولى من صيامي ، إنها المرة الأولى التي أصوم فيها كامرأة مسلمة ، وهو أمر أنا ممتن له وفخور به. الظروف التي تكمن وراء صيام هذا العام لها نوع مختلف من الدلالات – على سبيل المثال ، أنا لا أصوم فقط بسبب الاختيار الغريب كما فعلت في العام الماضي ، بل بسبب الرغبة في الوفاء بالالتزام الديني

هذا العام خاص لأسباب عديدة. في حين أنها ليست السنة الأولى من صيامي ، إنها المرة الأولى التي أصوم فيها كامرأة مسلمة ، وهو أمر أنا ممتن له وفخور به. الظروف التي تكمن وراء صيام هذا العام لها نوع مختلف من الدلالات – على سبيل المثال ، أنا لا أصوم فقط بسبب الاختيار الغريب كما فعلت في العام الماضي ، بل بسبب الرغبة في الوفاء بالالتزام الديني
أخبار
أمريكا : حرق المركز الإسلامي بتكساس وتسويته بالأرض
نيويورك – أمريكا | أحوال المسلمين
نشبت نِيران في المَركزِ الإسلامي بمدينة فيكتوريا بولاية تِكساس الأمريكية في تَمام الساعة الثانية من صباح أمس السَبت، مما أدت الى احتراقه بالكامل.
وقد تَمكنت قُوات الإطفاء من إخماد النِيران بعد حَوالي أربع ساعات من عمليات الإطفاء، و ذكرت السلطات حينها أنه لم يُسفِر الحَريق عن أية إصابات.
وقال شَهيد هاشِمي رئيس المَركز الإسلامي مُستنكرًا ما حَدث ” إنَّها دار للعِبادة”، وعلى الرَغم من تَعرض المَركز لِعملية سَطو في 21 يَناير الجاري إلا أن شَهيد رَفض التَكهُن بأن الحَريق كان عَمدًا وصَرح أنه لا يعَرف أسباب الحَريق.
يُذكر أنه في عام 2013 كُتب على أحد جِدران المَركز الإسلامي عِبارات الكَراهية ضد المسلمين و تدعوهم بالإرهابيين.
وقد أعلن القائِمون على المَركز أنهم سيُعيدوا بناءه من جديد، و قاموا بتدشين حَملة لجمع التبرعات عبر موقع GoFundMe، و يُمكن لمن أراد دَعم إعادة البِناء أن يعابن ذلك من هنا.
الجَديرٌ بالذِكر أن هّذا المركز الإسلامي هُو المَسجد الثاني الذي يتم تدميره في تِكساس خلال هذا الشَهر، حيث تَم إحراق مَسجِد تحت الإنشاء بالقُرب من بُحيرة ترافيس في أوستن.
أخبار
أمريكا : هجوم وحشي على مسلمين اثنين خلال مغادرتهما المسجد في نيويورك

نيويورك – أمريكا | أحوال المسلمين
تعرض أمس مسلمين اثنين ينشطان ضمن جمعية “المسلمون يردون الجميل” الى اعتداء وحشي من طرف مجهول خلال خروجهما من المسجد، و قد أصيب أحدهما بارتجاج في الدماغ نتيجة تعرضه للكمات شديدة على وجهه من طرف المهاجم، بينما أصيب الشاب الآخر بكدمات على مستوى الوجه.
المهاجم الذي صاح “ارهابيون” عندما كان يهاجم الشابين، لاذ بالفرار بعد الهجوم، ثم لحقه مجموعة من المسلمين في محاولة منهم للإمساك به.
صور الضحايا
أخبار
أمريكا : طرد 190 عاملاً مسلماً من مصنع بولاية كولورادو بسبب أحتجاجهم علي منعهم من الصلاة

أصدرت الصحيفة الأمريكية “يو إس إيه توداى” خبراً أن حوالى 190 من العمال المسلمين، أغلبهم مهاجرون قادمون من الصومال، تم طردهم من العمل فى مصنع يسمي “كارجيل” لتعبئة اللحوم بمدينة فورت مورجان بكولورادو، بعدما تركوا وظائفهم خلال نزاع على الصلاة فى مكان العمل

جاء ذلك بعد أن غيرت الشركة المالكة للمصنع سياستها ضدهم، حيث كانت قد وفرت عام 2009 غرفة مخصصة للموظفين المسلمين من أجل أداء الصلاوات فيها، وبعد منع الشركة العمال من صلاة الجماعة قام العمال – أغلبهم صومالين- بتنظيم إضراب عبروا فيه عن أحتجاجهم في عدم كفاية وقت إقامة الصلاوات فقامت الشركة بطردهم جميعاً

وصرح “جيلانى حسين” يعمل بـ “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” ، أن المسلمين يصلون خمس مرات فى اليوم، ويختلف موعدها حسب الفصول، مضيفا أن المصنع قام بطرد أغلب العمال الذين تركوا العمل
علي الصعيد الأخر أوضح العمال أنهم فى وقت مبكر من الشهر الماضى تم تغيير سياسة المصنع، فيما يتعلق بالسماح لهم بالصلاة خلال أداء عملهم، وجعل بعضهم غير قادرين على الصلاة على الإطلاق

من جانبها، ردت إدارة مصنع “كارجيل” على ذلك فى بيان، مؤكدة أنهم لم يغيروا سياستهم المعلقة بالحضور والتوفيق الدينى، مشيرة إلى أنه تم تأسيس منطقة يستخدمها جميع العاملين للصلاة فى إبريل 2009، ومتاحة خلال نوبات العمل بناء على قدرتهم على وجود عدد كاف من العاملين فى منطقة العمل، موضحة أنه رغم بذل جهود معقولة لجعل العاملين قادرين على القيام بالتزماتهم الدينية، إلا أن هذا ليس مضمونا كل يوم، ويعتمد على عدد من العوامل الذى يمكن أن تتغير من يوم إلى آخر، وأرجع المصنع فصل العمال إلى انتهاكهم لقواعد العمل الخاص به لغيابهم ثلاثة أيام متتالية دون إبداء أسباب
ولكن صرح “خضر دوكال”، وهو من يساعد العمال الصوماليين على التقدم بطلب إعانة البطالة، أن الصلاة هى الأولية الأولى لكل مسلم، مضيفاً أنه يمكننا أن نبقى بلا وظيفة ولا يمكن أن نستمر بلا صلاة ومحاولة تبرير الشركة ما فعلته بأنها تقوم بكل المحاولات لتوفير أماكن إقامة الشعائر الدينية لكل الموظفين بقد الإستطاعة شرط ألا يتسبب ذلك في إنقطاع العمل أمر غير منطقي، فأقصي مده لساعات العمل لا تزيد عن ثماني ساعات وهي مدة تضم ما بين صلاتين إلى أربع علي أكثر تقدير طبقاً لمواقيت الصلاة في ولاية كولورادو ومده الصلاة لا تزيد عن عشر دقائق، وأنه لو عرض علي العمال خصم لرحبوا بذلك لحرصهم علي أداء الصلاة
http://https://www.youtube.com/watch?v=yO9_fkAb-lE
تأتي الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المنتشرة في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار تصاعد حدة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الآونة الأخيرة، حيث يعاني المسلمون من التمييز والإضطهاد في أماكن العمل
هذا ويمثل المسلمون ما يزيد عن 8 مليون نسمة في المجتمع الأمريكي ومنهم أعضاء عاملون وفاعلون ويعتبر هذا الفعل العنصري يخالف كافة الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان التي تنادي بها الولايات المتحدة
أمريكا
أمريكا : بالتزامن مع قرار وزير الدفاع الأمريكي بالإفراج عن 17 من معتقلي غوانتانامو، عامر شاكر يحكي مأساته بالمعتقل

أحوال المسلمين – واشنطن أمريكا
صرحت صحيفة ” نيويورك تايمز” يوم أمس، الأربعاء 21/12/2015، نقلاً عن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع الأميركي “اشتون كارتر” أبلغ الكونغرس مؤخرا أنه قد وافق على نقل 17 من المحتجزين بمعتقل غوانتانامو
وأضاف المسؤول الأمريكي قائلاً ” وجدنا أماكن لاستضافة المعتقلين الـ17 مشيرا إلى أن دولا عدة وافقت على استقبال هؤلاء المعتقلين ، ورفض كشف الدول التي وافقت على استقبال المعتقلين” وسيتم نقل المعتقلين منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، أي بعد ثلاثين يوماً على إبلاغ الكونغرس بذلك
وعلى صعيد أخر جاء في بيان لــ ” نورين شاه” مديرة برنامج “أمن مع حقوق الإنسان” في فرع الولايات المتحدة لمنظمة العفو الدولية أن “نقل المعتقلين الـ17 سيكون قفزة إلى الأمام، بالمقارنة مع البطء في عمليات النقل في الماضي
وأضافت أن ذلك “سيشكل إشارة إلى أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، جاد في إغلاق غوانتانامو خلال ولايته، وهو أمر أساسي لأن الإدارة المقبلة يمكن أن تحاول إبقاءه مفتوحاً إلى ما لا نهاية”، على حد تعبيرها
يذكر أن المعتقلين الـ17، الذين سيتم نقلهم، هم جزء من مجموعة تضم 48 معتقلاً وافقت السلطات العسكرية الأميركية على الإفراج عنهم، شرط العثور على أماكن مناسبة لاستقبالهم، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من هؤلاء يمنيون ولا تمكن إعادتهم إلى بلدهم في الوقت الراهن
ويذكر أن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، قد صرح إنه يتوقع تقليل عدد معتقلي غوانتانامو إلى ما دون المئة مع حلول العام القادم 2016 وأكد في مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام أنهم سوف يستمرون في تقليص الأعداد (المعتقلين) في غوانتانامو بشكل ثابت
وتابع قائلا: “سوف نصل إلى نقطة لا يمكن معها تقليص العدد، لكونهم يشكلون” خطرا كبيرا “، علي حد تعبيره في إشارة إلى سجناء في غوانتانامو، تعدهم واشنطن يهددون مصالحها الأمنية ولا تنوي نقلهم إلى بلد آخر
ويرفض الكونغرس الأمريكي فكرة إغلاق المعتقل، ويعتبرها تهديدا للأمن الداخلي للبلاد، وعبر الرئيس الأمريكي أنه سيعمل مع الكونغرس لإغلاق المعتقل، مشيرا إلى “أنه من غير المنطقي بالنسبة لنا أن ننفق 100 مليون دولار إضافية، أو 200 مليون دولار أو 300 مليون دولار أو 500 مليون دولار أو مليار دولار لتأمين سجن لـ 50 أو 60 أو 70 شخصا
ولفت إلى أن الجماعات الإسلامية تستخدم خطابا ينطوي على أن “الظلم الفادح، هو أن الولايات المتحدة لاتطبق قيمها العليا التي تدعي تبنيها” ، وبيّن أن هذا السبب هو ما يدفع إلى محاولة غلق المعتقل سيئ الصيت
يذكر أنه تم الإفراج عن أخر سجين “بريطاني الجنسية” سعودي المنشأ، بمعتقل غوانتنامو وهو “شاكر عامر” بعد 14 عاماً قضاها في المعتقل وذلك في أكتوبر من هذا العام

.
شاكر عامر يحكي مأساته في غوانتنامو
وقد قرر “شاكر عامر” الخروج عن صمته والكشف عما تعرض له من تعذيب ومعاناة طيلة 14 عاما قضاها في هذا المعتقل سيئ السمعة، في سلسلة لقاءت مع وسائل الإعلام العالمية، بدأها مع صحيفة ديلي ميل الأحد 13 ديسمبر2015 والحلقة الأولى منها في هذا التقرير
بدأ روايته باليوم الذي وصل فيه جوانتانامو وتم وضعه في زنزانة صغيرة جدا، لا يستطيع حتى النوم فيها، قائلاً: إذا أردت النوم يصبح وجهك في المرحاض. وجاء الحراس الذين يصفهم بأنهم “مخيفون أجسامهم ضخمة مفتولو العضلات لا يتفاهمون ولا يترددون في إيذاء أي سجين” ، وطالبوا منه الانبطاح أرضا، ثم قاموا بضربه بالدروع التي يحملونها، وبعد ذلك جلسوا فوقه مما جعله لا يستطيع التنفس
ويصف عامر، حاله في تلك اللحظة بأنه كان عبارة عن قطعة لحم داخل سندويتش.فيقول إن الحراس ظلوا يصرخون “لا تقاوم.. لا تقاوم”، .. أنا لا أقاوم .. كيف لي أن أقاوم ؟

ويتابع السجين السعودي الذي تم الإفراج عنه في 30 اكتوبر2015، أن الغريب أن جلسات التعذيب هذه كان يتم تصويرها، وكانت بعض هذه الجلسات تتم من أجل تدريب هؤلاء الحراس
وأضاف أنهم كانوا يعتبرون ذلك قتالا وحربا، إنهم يظلون يصرخون لا تقاوم يا سجين رقم “239”، حيث كان هذا الرقم التعريفي له منذ وصوله إلى المعتقل

ويقول عامر ان الطريقة المفضلة لهم في التعذيب والتي بدأت منذ اعتقاله في أفغانستان وحتى قبل وصوله إلى جوانتانامو هي تقييد السجين على طريقة تقييد الحيوانات، عبر إلقائه على الأرض على وجه وتقييد رجليه ويديه خلف ظهره معا ، وانه في احدى هذه المرات ظل مقيدا لنحو 45 دقيقة
وأضاف أنه خضع لنحو 200 جلسة استجواب طيلة 14 عاما، ولكنه في عام 2005 سئم من كثرة هذه التحقيقات، ورفض الإجابة عن أي أسئلة في الاستجوابات اللاحقة. وأوضح أنه كان يتم نقله من زنزانة لأخرى كل فترة من الزمن، وأن الزنازين كانت أشبه بأقفاص الحيوانات، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذا السجن هو كسر الإرادة الإنسانية بالكامل حتى أنهم يطلقون على منطقة داخل السجن Rodeo Rangeوهي تعني المكان الذي يتم فيه تكسير الخيول
ويعتبر عامر، أن عام 2005 كان محوريا في تاريخ جوانتانامو، عندما تزعم هو إضرابا جماعيًا عن الطعام وكانت تلك هي المرة الأولى التي يحدث ذلك في المعتقل، وبناء على ذلك تم منعه من التواصل مع السجناء الآخرين
وتابع عامر، المتزوج من بريطانية وله 4 أبناء، أنه بعد مرور شهرين تم نقله الى المستشفى وأجبر على شرب المياه وتناول الطعام وبعد ان وأوشك على الموت، ولكن تم الاتفاق مع مسؤولي المعتقل على السماح ببعض المزايا في السجن عقب هذه الواقعة وتخفيف جلسات التعذيب

وقال شاكر عامر الذي تم اعتقاله من أفغانستان عام 2001، أن الزنزانة كانت مزودة بجهاز للصوت يبث أوامر ونداءات الحراس وان هذا الجهاز كان يستخدم من أجل تعذيب السجناء بشكل غير مباشر؛ حيث يتم إجبارك على سماع تعليمات الحراس وصراخهم طوال الوقت وكذلك عندما يقومون بتعذيب آخرين. وقال إنه في ذات مرة استخدم شوكة الطعام وقام بتعطيلها، وفتح إطار النافذة، وبدأ في النداء على الحراس وهو ما دفع العديد من السجناء للقيام بالمثل
وتابع إنه في إحدى المرات تم إجباره على المكوث في غرفة باردة جدا تكاد تقترب من درجة التجمد لمدة 36 ساعة.. وقال عامر إنهم كانوا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة في حياتك حتى أنهم منعوني ذات مرة من استخدام قشة الفاكهة في تنظيف أسناني، وعندما رفضت تعرضت للضرب والتعذيب
وقال السجين السعودي الذي ترك المملكة وسافر إلى الولايات المتحدة في سن الـ17، إن هول التعذيب والمعاناة لمدة 14 عاما يصعب سردها في مقابلة صحفية، مؤكدًا أنه كابوس مرعب طيلة 14 عاما
وكان عامر يُقيم في المملكة المتحدة مع زوجته البريطانية وأولاده الأربعة في جنوب لندن، قبل ان يسافر إلى افغانستان للمشاركة في بعض الأعمال الخيرية؛ ولكنه اعتقل هناك عقب أحداث سبتمبر2001، وتم نقله الى جوانتاناموا. وحصل على البراءة عام 2007 في عهد الرئيس جورج بوش، كما تمت تبرئته عام 2009 خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس أوباما، ولم يخضع -طول مدة احتجازه- للمحاكمة، ولم تتم إدانته بأي جريمة على مدى 14 عامًا